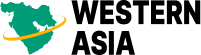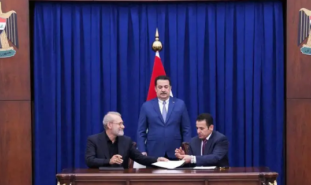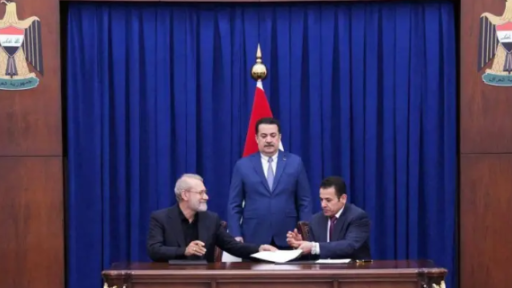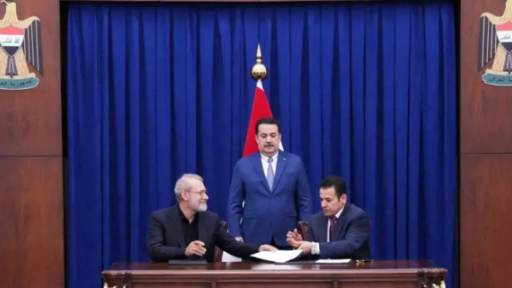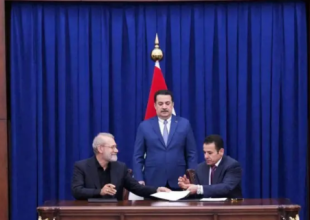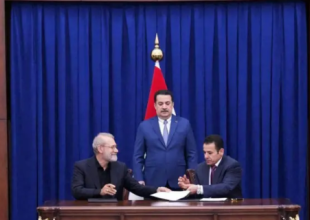نحاول في هذه المقالة الإجابة عن تساؤلات حول: كيف تآكل دول مصر التي كانت يومًا "قائدة للعالم العربي"؟ وما هي الأخطاء الاستراتيجية الفادحة التي ارتكبها النظام المصري في العقد الماضي وأدى للوصول إلى هذه الحالة من الضعف والتقزُّم؟ والأهم من ذلك، ماذا لو كانت مصر اليوم "مصر القوية" غير المثقلة بهذه الأعباء؟ ما هي الأوراق التي كان بإمكانها أن تلعبها لوقف الحرب في غزة ومنع المجاعة على حدودها وفرض واقع إنساني جديد على الأرض؟ وأخيرًا، هل ما زال في جعبة القاهرة ما تقدمه لتغيير مسار الأزمة، أم أن هامش المناورة قد تلاشى تمامًا؟
سنحاول تحليل السياسات التي أدت إلى تراجع الدور المصري، واستشراف ما كان ممكنًا، وطرح ما لا يزال ممكنًا في مواجهة إحدى أكبر الأزمات الإنسانية والوجودية أمام السياسة المصرية.
الأخطاء الاستراتيجية (2014-2024)
شهدت الأعوام العشرة الماضية تحولاً في استراتيجيات الدولة المصرية، ورغم تحقيق استقرار سياسي وأمني بعد فترة اضطراب، فإن حزمة من الأخطاء الاستراتيجية في إدارة شؤون البلاد قد أدت إلى تآكل تدريجي في دور مصر السياسي الإقليمي، الذي اتسم تاريخياً بالقيادة والتأثير. يمكن إيجاز هذه الأخطاء في النقاط التالية، المستندة إلى تحليل السياسات وتداعياتها:
1. ارتهان الاقتصاد لنموذج تنموي غير مستدام قائم على الديون
- الاستراتيجية المعتمدة: تبنى النظام نموذجاً تنموياً يرتكز بشكل أساسي على الاقتراض الخارجي المكثف لتمويل مشاريع بنية تحتية عملاقة (مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكات الطرق والقطارات فائقة السرعة، ومحطات الطاقة) [1]. كان المنطق الرسمي هو أن هذه المشاريع ستجذب الاستثمار الأجنبي وتخلق نمواً اقتصادياً سريعاً.
- الخطأ الاستراتيجي: تم إيلاء الأولوية لمشاريع ذات عائد اقتصادي طويل الأجل وغير مضمون، على حساب قطاعات إنتاجية حيوية (الصناعة والزراعة) قادرة على توليد تدفقات نقدية بالعملة الصعبة في المدى القصير والمتوسط. هذا التوجه أدى إلى تضخم هائل في الدين الخارجي الذي قفز من حوالي 46 مليار دولار في 2014 إلى ما يزيد عن 164 مليار دولار في مطلع 2024[2].
- الأثر على الدور الإقليمي: هذه المديونية الضخمة جعلت الاقتصاد المصري شديد الهشاشة أمام الصدمات الخارجية، ووضعت القاهرة تحت ضغط دائم من دائنيها (صندوق النقد الدولي ودول الخليج بشكل خاص). هذا الاعتماد المالي قلّص بشكل مباشر من هامش المناورة واستقلالية القرار في السياسة الخارجية، حيث أصبحت القرارات الاقتصادية والسياسية مرهونة بالحصول على حزم إنقاذ مالية، مما أضعف صورة مصر كقوة اقتصادية وسياسية مستقلة.
2. الإفراط في الاعتماد على الحلفاء الخليجيين ومواءمة السياسة الخارجية:
- الاستراتيجية المعتمدة: منذ عام 2013، اعتمد النظام بشكل كبير على الدعم المالي والسياسي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتثبيت استقرار الدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
- الخطأ الاستراتيجي: تحول هذا الدعم من مساعدة حليف لحليف إلى علاقة اتسمت بتبعية متزايدة. ففي مقابل الدعم المالي، قامت مصر بمواءمة سياستها الخارجية مع مواقف الرياض وأبوظبي في العديد من الملفات الإقليمية (مثل الموقف الأولي من الأزمة اليمنية، والعلاقات مع تركيا، والمشاركة في حصار قطر عام 2017). هذا الأمر أفقد الدبلوماسية المصرية دورها التقليدي كوسيط نزيه وموازن للقوى في المنطقة.
- الأثر على الدور الإقليمي: تخلت مصر فعلياً عن دور "الدولة القائدة" في العالم العربي، وبات يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها "تابع" لمحور الرياض-أبوظبي [3]. هذا التحول سمح لقوى إقليمية أخرى (مثل تركيا وإيران) بملء الفراغ الذي تركته مصر في مناطق نفوذها التقليدية (مثل القرن الإفريقي، ليبيا، والقضية الفلسطينية)، وبالتالي تقزّم دور القاهرة المحوري.
3. سوء إدارة أزمة سد النهضة الإثيوبي:
- الاستراتيجية المعتمدة: بدأت الاستراتيجية المصرية بمحاولة بناء الثقة مع إثيوبيا، وتوجت بالتوقيع على "إعلان المبادئ" في الخرطوم عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا بضغط [أو ابتزاز!] من البنك الدولي.
- الخطأ الاستراتيجي: كان التوقيع على إعلان المبادئ خطأً استراتيجياً فادحاً، حيث منح شرعية سياسية ودولية لبناء السد دون الحصول على أي ضمانات قانونية ملزمة بشأن قواعد الملء والتشغيل، أو آلية فض نزاعات فعالة [4]. اعترفت مصر بحق إثيوبيا في بناء السد قبل تأمين حقوقها المائية التاريخية. لاحقاً، فشلت الدبلوماسية المصرية في حشد ضغط دولي فاعل لوقف الخطوات الأحادية الإثيوبية، وتحولت القضية من "تهديد وجودي" يتطلب الحسم إلى أزمة تُدار بالتصريحات الإعلامية والمفاوضات المتعثرة.
- الأثر على الدور الإقليمي: أظهرت إدارة ملف سد النهضة عجزاً مصرياً عن حماية أحد أهم مصالحها الاستراتيجية (الأمن المائي)، مما أضر بصورتها كقوة إقليمية قادرة على فرض إرادتها أو على الأقل حماية مصالحها الحيوية. هذا الفشل شجع دولاً أخرى في حوض النيل وأفريقيا على تحدي المواقف المصرية.
4. قمع المجال العام وتغييب السياسة لصالح الحلول الأمنية:
- الاستراتيجية المعتمدة: إعطاء الأولوية القصوى للاستقرار الأمني والسياسي عبر تقييد الحريات العامة، وإغلاق المجال العام أمام أي معارضة سياسية، والاعتماد على الأجهزة الأمنية في إدارة العديد من جوانب الحياة العامة والاقتصادية.
- الخطأ الاستراتيجي: إن تغييب السياسة وإنهاء الحيوية المجتمعية لا ينتج استقراراً مستداماً، بل يخلق دولة هشة داخلياً تفتقر إلى المرونة والبدائل في مواجهة الأزمات. وأفقد الدولة التعاطف والعمق الشعبي وهو الداعم الأول في حالة المواجهة الصلبة وأفقدها الكثير من جوانب "القوة الناعمة" التي كانت تتمتع بها في السابق بسبب مناخ الحرية النسبي مقارنة بدول الخليج والدول الإفريقية [5].
- الأثر على الدور الإقليمي: فقدت مصر الكثير من "قوتها الناعمة" التي كانت تستمدها من ريادتها الثقافية والإعلامية والفكرية. كما أن نموذج الحكم القائم على القبضة الأمنية، بدلاً من المشاركة السياسية والتنمية البشرية، أصبح أقل جاذبية وإلهاماً في محيطها العربي والإفريقي، مقارنة بنماذج أخرى صاعدة. هذا التراجع في القوة الناعمة والمصداقية الدولية قلص من قدرتها على التأثير في الشعوب والأنظمة الأخرى.
في المحصلة، فإن السياسات التي انتهجها النظام المصري خلال العقد الماضي، وإن حققت أهدافاً تكتيكية على المدى القصير (مثل الاستقرار الأمني)، إلا أنها ارتكبت أخطاء استراتيجية بعيدة المدى أدت إلى تآكل أسس القوة المصرية التقليدية: اقتصادها المنتج، واستقلالية قرارها السياسي، وتأثيرها الدبلوماسي، وقوتها الناعمة. والنتيجة هي تقزّم الدور الإقليمي الذي كانت تلعبه مصر تاريخياً، لصالح قوى إقليمية أخرى كانت أكثر مرونة وذكاءً في إدارة مواردها وتحالفاتها.
ما الذي كان يمكن أن تقوم به مصر لولا هذه الأخطاء الاستراتيجية؟
لو لم تكن الدولة المصرية مكبّلة بالأخطاء الاستراتيجية التي حُدّدت سابقاً، والتي أدت إلى تآكل استقلاليتها وقدرتها على المناورة، لكان بإمكانها اتخاذ سلسلة من الإجراءات المؤثرة لوقف الحرب في قطاع غزة وإنهاء المجاعة. هذه الإجراءات، التي تتطلب قوة اقتصادية، واستقلالية سياسية، وعمقاً استراتيجياً، كانت ستغير مسار الأزمة من خلال المضي في إجراء أو إجراءين من بين أكثر من عشرة إجراءات كان يمكن لـ"مصر القوية" اتخاذها:
- التهديد بتعليق اتفاقية (كامب ديفيد): كان بإمكان مصر، لو لم تكن تعتمد بشكل مفرط على المساعدات الغربية والدعم السياسي المرتبط بها، أن تستخدم ورقتها الاستراتيجية الأقوى. عبر إصدار تحذير رسمي وعلني بأن استمرار العمليات العسكرية في (رفح) وفرض الحصار والتجويع سيجبر (القاهرة) على تعليق العمل ببنود أساسية في معاهدة السلام، خاصة التنسيق الأمني، مما يخلق أزمة استراتيجية كبرى لـ(إسرائيل) و(الولايات المتحدة).
- فتح معبر (رفح) بالقوة السيادية وفرض إدخال المساعدات: بدلاً من انتظار الإذن الإسرائيلي، كان بإمكان مصر، التي لا تخضع لضغوط اقتصادية خانقة، أن تعلن أن معبر (رفح) هو معبر مصري-فلسطيني يخضع للسيادة المصرية الكاملة، وأنها ستقوم بإدخال مئات الشاحنات يومياً تحت حماية مصرية، وتحدي أي طرف يحاول اعتراضها، معتبرة أن منع المجاعة على حدودها هو مسألة أمن قومي مباشر.
- قيادة تحالف دولي للضغط السياسي والاقتصادي: مصر المستقلة بقرارها، وغير المرتهنة لتحالفات إقليمية ضيقة، كان بمقدورها حشد تحالف من الدول العربية والإفريقية ودول من الجنوب العالمي (مثل جنوب إفريقيا والبرازيل) لفرض حزمة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية منسقة على (إسرائيل)، وعزلها في المحافل الدولية بشكل أكثر فعالية من التحركات الفردية.
- إقامة منطقة آمنة ومستشفى ميداني عملاق داخل حدود غزة: كان يمكن لمصر، بقوتها العسكرية واللوجستية، أن تبادر بإنشاء منطقة آمنة واسعة داخل قطاع غزة بالقرب من الحدود المصرية، تحت حماية قوات مصرية (أو قوات عربية مشتركة بقيادة مصرية)، ونقل المستشفيات الميدانية إليها لتوفير الرعاية الطبية لمئات آلاف النازحين، وفرض هذا الواقع على الأرض كخطوة إنسانية لا يمكن الطعن فيها.
- لعب دور "الراعي" وليس "الوسيط" في الملف الفلسطيني: بدلاً من لعب دور الوسيط المحايد الذي ينقل الرسائل بين (حماس) و(إسرائيل)، كان بإمكان مصر القوية أن تتبنى دور "الراعي" للموقف الفلسطيني الموحد. عبر استضافة حوار وطني فلسطيني شامل في (القاهرة) لإنتاج قيادة فلسطينية موحدة وبرنامج سياسي واضح لمرحلة ما بعد الحرب، ثم تقديم هذا الموقف للعالم باعتباره الموقف الذي تدعمه (القاهرة) بكل ثقلها.
- تغيير قواعد الاشتباك في سيناء: كان يمكن للجيش المصري، لإظهار الجدية ورفع كلفة أي عملية عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود، أن يعلن عن تغيير في قواعد الانتشار العسكري في سيناء (المنطقة د)، وزيادة حجم القوات والمعدات الثقيلة بشكل يتجاوز المسموح به في اتفاقية السلام، كرسالة ردع مباشرة بأن أمن الحدود المصرية خط أحمر.
- تقديم دعم مباشر للسلطة الفلسطينية لإدارة المعابر: كان بإمكان (القاهرة) تدريب وتجهيز قوات أمن فلسطينية تابعة للسلطة الوطنية، والدفع بها لتسلم إدارة الجانب الفلسطيني من معبر (رفح) ومعبر (كرم أبو سالم) تحت إشراف مصري-دولي، لسحب الذرائع الأمنية الإسرائيلية وخلق أمر واقع جديد لإدارة المعابر.
- شن حملة دبلوماسية وقانونية دولية منظمة: بدلاً من الاكتفاء بدعم تحرك (جنوب إفريقيا) في محكمة العدل الدولية، كان بإمكان مصر أن تتقدم بقضية خاصة بها، مستخدمة ما لديها من معلومات استخباراتية وشهادات لتوثيق جرائم الحرب، وقيادة حملة قانونية دولية شاملة في جميع المحاكم والمنظمات الدولية (الجنائية الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان) لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
- استخدام ورقة الغاز الطبيعي وعلاقات الطاقة: مصر التي لا تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، كان بإمكانها التلويح بمراجعة اتفاقيات استيراد وتصدير الغاز مع (إسرائيل) واتفاقيات منتدى غاز شرق المتوسط، وربط استمرار هذه الشراكات الاقتصادية الحيوية بوقف فوري للحرب وإنهاء الحصار.
- حشد الرأي العام الداخلي وتوظيفه كورقة ضغط: إن نظاماً سياسياً يستمد قوته من شعبه، وليس من الأجهزة الأمنية، كان بإمكانه السماح بتظاهرات شعبية حاشدة ومنظمة للتعبير عن الغضب تجاه ما يحدث في غزة. هذا الحشد الشعبي لم يكن ليعبر عن موقف الشعب فقط، بل كان سيستخدمه النظام كورقة ضغط هائلة في مفاوضاته مع الأطراف الدولية، لإظهار أن استقرار مصر نفسه مرتبط بإنهاء هذه الأزمة.
ما الذي لا زال بإمكان النظام المصري فعله؟
بالرغم من كل ذلك لازال هناك مساحة لممارسة الدور الإنساني يحفظ ماء الوجه على الساحة الدولية والشعبية، ويؤكد حضور مصر في الأزمة دون الانجرار إلى مواجهة:
- استقبال المصابين في مستشفيات ميدانية.
- تقديم مطار وميناء (العريش) كمركز لوجستي دولي للمساعدات للدول والهيئات الراغبة في حشد المساعدات حتى لو لم يمكنها إدخالها ما يمكن أن يمثّل ضغط دولي على الجانب "الإسرائيلي".
- السماح بجمع التبرعات الشعبية داخل مصر من خلال القنوات الرسمية والشرعية ما يخلق توتّر في الداخل "الإسرائيلي" الذي يخشى من رأي عام مصري غاضب.
- السماح لكافة الوفود الدولية بالوصول إلى معبر رفح وتأمين سيرها من "البلطجية" التي تتهم الدولة المصرية بتحريكهم لاعتداء على الوفود.
- السماح لسفن كسر الحصار الدولية بممارسة "حق المرور الآمن" – “Safe Passage” في المياه المصرية للوصول الى غزة بدون المرور بالمياه "الاسرائيلية".
المصادر
[1] Carnegie Endowment for International Peace. (2024). Misfortune to Marginalization: The Geopolitical Impact of Structural Economic Failings in Egypt, Tunisia, and Lebanon.
[2] بيانات البنك المركزي المصري وتقارير صندوق النقد الدولي.
[3] Masr360. (2023). Cairo in the Shadow of the Gulf: "Egypt is not too big to decline".
[4] Al Jazeera Centre for Studies. (2019). The Renaissance Dam: Dimensions of the Crisis and the Confrontation between Egypt and Ethiopia.
[5] Carnegie Endowment for International Peace. (2019). Egypt’s Political Exiles: Going Anywhere but Home