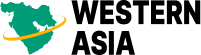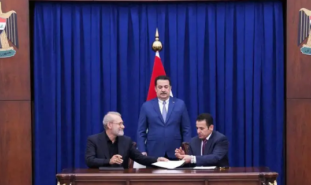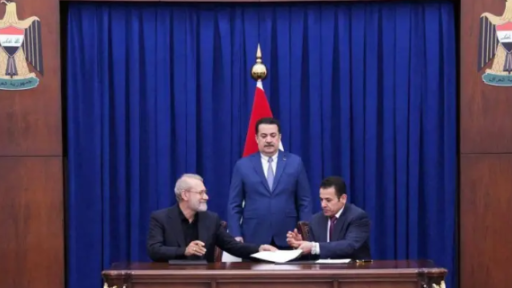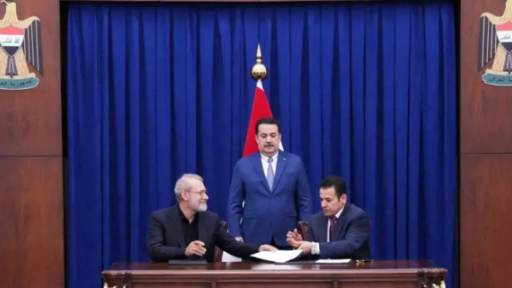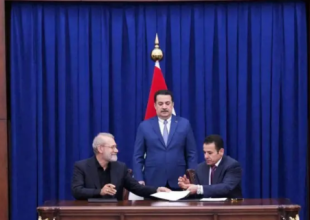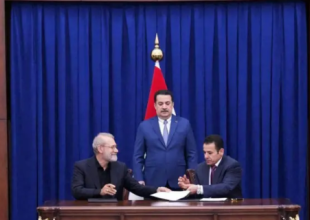في حرب الإبادة الجماعية، لا يكتفي الاحتلال بقتل الإنسان فحسب، بل أيضاً يسعى لقتل إنسانية الغزيين باستخدامه سلاح التجويع، فيستفزُ به غرائزَ الإنسان التي لا يقدرُ على ضبطِها في ظل الجوعُ أبداً.
وها نحن منذ أشهُر ملقَونَ في أتون المجاعة لا نملكُ لصدّها سبيلاً، إذ فرغتِ المنازل والأسواق من كل شيء يصلح للأكل، ولم نعد نهتم بالاتفاقات والهُدن كما كان عهدنا أول أيام الحرب، إنما همنا الأكبر وشغلنا الشاغل رغيف الخبز وكيفية توفيره، ولا مبالغةَ في قولِ إننا لا نجد الطعام حرفياً، فيمرُ أسبوعٌ وأسبوعان من دون أن نرى رغيفَ الخبز عوضاً عن نعيم تناولِه.
وقد أدركنا - وليتنا لم ندرك - أن الأسلحةَ مهما يبلغ فتكها، فهي لن تبلغَ الجوعَ فتكاً.
ربما يستطيع الإنسان أن يحيا لأيام أو أسابيع بلا طعام، وهذا حالُ مَن انقطع عنه الطعام تماماً، ولم يكن يملك سبيلاً إليه. لكن في غزة، بعد أن بلغتِ المجاعة حداً لا يُوصف، وبعد أن أراد المحتل أن يبيّض صفحته أمام صحوة العالم المتأخرة جداً ويستأنف المساعدات، وجدنا أنفسنا أمام واقع جديد، اقترن فيه الطعام بالموت، ولم يعد للطعام طريقاً إلاّ وكانَ محفوفاً بالموت، فأصبح الجائعون لا يموتون بسبب الجوع في الأغلب، إنما بسبب محاولات سدّه.
ولم تعد مسألة البقاء على قيد الحياة في غزة مرهونة بما يتوفر من الطعام بقدرِ ارتهانِها بالقدرة على تحصيله بأي ثمن - حتى ولو كان الثمن روحك - وكثيرون قُتِلوا في سبيل طعامهم بالنيران الصهيونية، واختناقاً بين جموع الجائعين، ودهساً أسفل الشاحنات، وبكل الطرق، لكن للسبب نفسه؛ لقمة العيش.
وقد أرادَ الاحتلال أن يجعل من التجويعِ أداة للإبادة والإذلال والإرهاق والتهجير في آخر الأمر، فأوجدَ بدعم أميركي "مؤسسةَ غزة الإنسانية" التي ستفتتح 4 مراكز لكل قطاع غزة: 3 منها في رفح المُبادَة، وآخَر في نيتساريم بين شمال غزة وجنوبها.
هذا غير شاحنات المساعدات القليلة التي يمررها الاحتلال بين الحين والآخر، جاعلاً منها فتنة للناس ومدعاة إلى الفوضى والاقتتال، فيتجمع الجائعون في طريقها، فتصلُ، وليتها لا تصل، ليس كرهاً للخير، إنما إشفاقاً على الجائعين الذين سيموت منهم الكثير في محاولاتهم المهينة المذلِّة في اعتراض الشاحنات.
وقد كانتِ المجاعة لا تفتأ تشتدُ يوماً وراء يوم، وكل يوم كان يمرُّ أسوءَ من الذي قبله؛ ففي بداية أمرهم، كان الجوعى قد رفضوا تلك المراكز التي تهدفُ إلى قتل الفلسطينيين وإذلالهم ومن ثم تهجيرهم، لكن في النهاية، لم يبقَ لأهل غزة ما يراهنون عليه، فالمعابر ستظل مغلقة، والعالم وقف عاجزاً أمامَ فتحها، وبالتالي، فإنهم فقدوا رفاه الامتناع عما فيه موتهم وذلهم وتهجيريم، وترسخت المعادلة أخيراً، واقترن الطعام بالدم والمهانة والهلاك بلا رجعة، فإمّا الطعام، وإمّا الموت.
ولم يكن التجويع في غزة مجردَ حرمان من الطعام، بل أيضاً كان مصيدةً للقتل والتهجير، وأداةً للتطهير العرقي والتهجير القسري.
وقد أخذتِ المجاعة لبَّ الناسِ، كباراً وصغاراً، مآخذَ الحضيض، فتوقّدت في الجائعين غرائز البقاءِ، وهمد على أعتابها كلّ ما ميّز البشرَ من ضروب الإنسانية.
ولمن البقاءُ إذن؟
إنه لِمَن يقدرُ على إطعام نفسه بأي ثمن، وينتزعُ طعامَه من تحتِ فوّهات المدافع والرشاشات، ولا عزاءَ لمَن أقعدتهم كرامتهم أو عجزهم عن هذا السبيل.
وطبعاً، فإن تلك الفوّهات الحاقدة لا تختزنُ أسفلها سوى ما يكفي أقل القليل من المجوَّعين الذينَ اضطروا إلى مجابهة الموتِ في سبيل طعامهم. وحتى مَن أخذ على نفسه انتزاع طعامه بالطريقة التي فرضها المحتل لن يفلحَ عهدُه بذلك، وسيعودُ من رحلته المضنية المهلكة وقد استزداد جوعه جوعاً. فكم من جائعٍ عادَ إلى أهله خاويَ الوفاض، أو شهيداً أو جريحاً، ولم يكسب الذين يعيلهم سوى الحسرات ومزيداً من الجوع.
وتكثرُ الحكايات عن أولئك الخائبين، الذين خابتْ جهودهم في تحصيل كيلوغرام واحد من الطحين، وكذلك الذين ماتوا من دون ذلك الشيء القاتل (الطحين).
تلك الأم التي سرقت منها الحربُ زوجَها، تاركاً وراءَه العديد من الأطفال الذين فتك الجوع بهم، ما كان لها إلاّ أن تذهبَ إلى مركز توزيع المساعدات في رفح من أجل إطعامهم، وعادت إليهم مُكفّنة، فخسرَ الأبناءُ والدَيهم، وكسبوا الجوعَ والحسرةَ والضياع.
وخلال كتابتي هذه الكلمات صباح 20 تموز/يوليو 2025، قتلَ الاحتلال أكثر من 50 جائعاً تجمّعوا عند منطقة زيكيم شمالي القطاع المنكوب، لا يريدون إلاّ شوال طحين قوتاً لأبناءهم لكي يعيشوا بضعة أيام أُخرى في هذا العالم الوحشي. وكذلك في 19 تموز/يوليو، قتل الاحتلال أكثر من 30 جائعاً عند مركز توزيع المساعدات في رفح.
هذا كله في الوقت الذي يفسدُ فيه الطعام ويُطرح أرضاً بعد أن طرحَ الجوع إنسانيتنا على الجانب المصري من معبر رفح.
لم تكتفِ المجاعةُ بتقطيع البطون، بل أيضاً عصفت هوجاؤها بالأذهان، فبدّلت من سلوكياتنا وطباعِنا وثقافتِنا وآرائِنا.
وكأيِّ حدثٍ في الحياة يترك ندوباً في العقول، فإن الجوع مشهود له بآثاره التي لن يمحوها الزمن مهما يتقادم عليها. وقد ازدادتِ العصابات، واستفحلت الجريمة، وتأججت الأنانية، ونُحِر الانتماء؛ فالجوعُ يُخرج الإنسان من عقالِه، وينسله من كرامته.
ولا يأتي الجوعُ على الأجساد فحسب، بل أيضاً تجوعُ في إثرِه النفوس. وكما يرتدُّ أثر الجوعِ على الأجساد ألماً وهُزالا، يرتدُ أيضاً على النفوسِ حزناً وغضباً وحقداً وغِلاًّ، فتستبدلُها النفوسُ بالعواطف والمشاعر التي ندعوها رقيقة وإنسانية، فتخشن الحياة، وتصبح العواطف والمشاعر شيئاً من ترف العيش ونعيمه. فهل سيفرغُ لهذا الهراء ويجدُ في عقله مُتسعاً له مَنْ تلبّس عقله بغريزة البقاء، وهام في الأرض لا يريد سوى كسرة خبز؟
وقد عاش أغلب أطفال غزة لأشهرٍ يشتهونَ رغيفاً من الخبز، وكأنهم لا يريدون من الدنيا سوى ذلك الرغيف. إذن، لن يجيبوك إذا سألتهم عن أحلامهم؛ إن كانوا يريدون أن يصبحوا كآباءَهم، أو عن أي أحلام مترَفة أُخرى. وقد قالت إحدى الأمهات إن ولدَها قال لها أنه إذا استُشهد، فهو يتمنى أن يرى في الجنة طعاماً، وقد قضى هذا الحالم الجائع شهيداً في حرب الإبادة، ولم يمضِ على الإفصاح عن أمنيته لأمه سوى بضع ساعات.
وربما نحنُ الكبار أدركنا حياة غير حياة الحرب التي نحياها الآن، ونوقنُ أبعادَ ما نمرُ به من تجويعٍ وتقتيل وإبادة، لكن الأمر مختلف جداً عند الأطفال الذين يعتبرون الحربَ أمراً واقعاً لا يقدرون على تخيُّل حياة من دونها، وباتوا يعدّونَ الشبعَ خطيئة، والرغيف الكاملَ غايةَ الحياة.
علامَ سيكبرُ هذا الطفل المجوَّع الذي رأى كل أشكال الموت أمام عينيه؟
وهكذا، جعل الاحتلال من التجويع أداة للإبادة والتهجير، وأكبرُ دليل على ذلك "مؤسسة غزة الإنسانية" التي يُقتَل في أيام عملها العشراتُ من المجوَّعين، فما إن بلغَ شهرٌ على عملها، حتى قُتِل على أعتابها أكثر من 500 جائع. هي تلك المؤسسة غير الإنسانية التي تستحقُ عشرات المقالات الأُخرى بشأن انتهاكاتها المستمرة للإنسان الفلسطيني. ولم يخلُ يوم من أيام المجاعة التي نعيشها منذ أشهُر من عشرات الضحايا الذين أودى بهم جوعهم إلى الموت والهلاك.
وفي النهاية، فإن كل ما نريده فقط ألاّ نموت من الجوع، ونحن مستعدون لكل شيء آخر، ويمكننا تكبّد عناءَ احتمالِه. نريدُ أن نأكل فقط، حتى لو كان فتاتاً مما يُهدره العالم القائم على الاستهلاكية المفرطة ويكون مصيره حاويات القمامة يومياً. ذلك الطعام المهدَر يكفي غزةَ أشهراً.